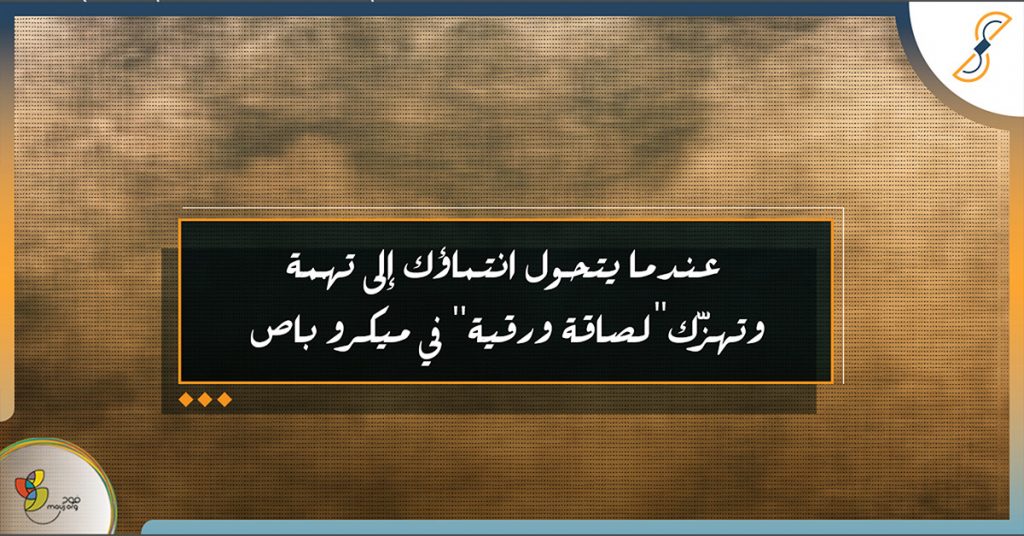كتابة :
بدأت القصة عندما عدتُ من زيارة مدينة جرمانا بريف العاصمة دمشق، وأخبرت أصدقائي/ وصديقاتي أنني عائدٌ للتو من هناك، حيث رمقني الجميع بنظراتٍ مريبة، فيها مزيجٌ من المزاح السمج والتشكيك. بمعنى أن زيارة هذه المدينة لا يمكن أن تكون طبيعيةً بل لا بد أن تحمل غايةً مريبة أو فعلاً مشين، تماماً هذا ما قرأتُه في أعينهم/ن ونظراتهم/ن وتلميحاتهم/ن.
كان ذلك بسبب “الطمّاعين”
“مدينةُ جرمانا تعرضت لتشويه متعمد وصار اسمها مرتبط بسمعة سيئة للغاية لا تشبه سكّانها”
هذا ما سمعتُه من العم أبو فيصل صاحب بقالية في أحد أحياء المدينة، وهو رجل سبعيني، روى لي قصصاً وأحداث مرّت على المدينة خلال حوالي نصف قرن، ألقى خلال حديثه اللوم على من أسماهم بـ “الطمّاعين” من “سكان المدينة” الذين باعوا منازلهم لأشخاص من خارج المدينة منذ منتصف التسعينيات، حيث يَعتبر أبو فيصل أن ملامح المدينة راحت تتغير منذ ذلك الحين وبدأت تكتظ أكثر بالسكان وتفقد طابعها الخاص الذي شبهّهُ بالقرية الكبيرة التي يعرف سكّانها بعضهم البعض.
شهدت جرمانا موجات نزوح عدة سواء من ” العراقيين/ـات ممن أتوا المدينة أثناء حرب العراق ، أو من السوريين/ـات الذين أصبحت المدينة وجهتهم/ن يوم دارت معارك في معظم المحافظات السورية، حالها كحال مناطق أخرى بقيت بعيدة عن العمليات القتالية ضمن أحيائها واقتصرت على القذائف والتفجيرات خلال سنوات الحرب، و”لكونها منطقة (تعتبر رخيصة من حيث المعيشة وتكاليف السكن إلى حدٍ ما)، وكأيّ منطقةٍ شعبية وفقيرة ومكتظّة انتشرت فيها ظواهر مثل الدعارة، أو المخدرات وغيرها، وباتت لاحقاً أشبه بتهم ملاصقة للمدينة وحتى لسكّانها” حسب دانا وهي طالبة إعلام تقطن في مدينة جرمانا منذ سنوات.
مدينة وصمت ب أشكال الصور النمطية
هذا الحديث عن جرمانا كنموذج لمدينة وصمت بالعديد من أشكال الصور النمطية، كالوصم الاجتماعي والطبقي والأخلاقي، والتي شكّلت عبئاً ثقيلاً على سكّانها، يقودنا للبحث عن نماذج أخرى لمجموعات من السوريين/ـات الذين/اللواتي عانوا/ـين على مدار سنوات من صورة نمطية ارتبطت بمناطقهم/ـنّ وتعممت على أبنائها/بناتها وقد لا تحمل أساساً متيناً حيث أنّها مجرّد “أحكام مسبقة تنتقل بالتواتر بين الناس ولا تخضع للتصحيح أو للتدقيق، وقد يَعتبر/تعتبر صاحب/ـة تلك الأحكام أنها غير مؤذية وعاديّة، إلا عندما يقيس/تقيس الأشياء على نفسه/ـها، عندها فقط يتوقف/تتوقف عن إطلاق الأحكام المسبقة والسماح للصور النمطية بالسيطرة على تفكيره/ـها”.. هذا ما قاله سعيد طالب في كلية الطب في جامعة دمشق.
إذ كان سعيد يملك نظرة مختلفة عن أهالي تلك المنطقة، هذه النظرة التي وصفها بالمتعالية معتبراً أن السبب في ذلك يعود إلى قلة المعرفة حول نمط حياتهم/ن، إلا أن نظرته هذه اختلفت كليّاً في الوقت الحالي، فقد كان لحياته الجامعية ولقائه بأبناء/بنات المناطق المختلفة مساهمة كبيرة في تكوين الصور الصحيحة عنهم/ن. وبات مقتنعاً أن لكل جماعة حياتها الخاصة ولا يمكن أن يكون الجميع متشابهون/ــات.
وعلى المقلب الآخر يقول محمد فرح وهو نازح من قرية جبّاتا الزيت من الجولان السوري المحتل، إن الكثير من الأشخاص يتجنبون التقرّب منه عند معرفتهم بأنّه “نازح”، حتى أن أحد أصدقائه غيّر طريقة معاملته له بعد معرفته بأنه من النازحين.
يعترف الكثيرون/ـات بـ “هشاشة” أحكامهم/ن المسبقة المعممّة على أفراد أو جماعات بناءً على عرقهم/هن، أفكارهم/هن، طريقة حياتهم/هن، لهجاتهم/هن، معتقداتهم/هن الدينية، أو حتى حالتهم/هن المادية أو المنطقة التي يسكنون فيها، وغيرها من المعايير، التي يغذّيها الانغلاق على الذات والجهل بالآخر، وعدم تقبّل الاختلاف. الأمر الذي ينتهي بنوع من الخوف تجاه الآخر أو الحذر غير المبرر. قد لا يدرك المساهمون/ـات بإنشاء تلك الصور النمطية عن جماعات بشرية أنّ هناك أذيةً نفسية ستلحق بأبناء هذه الجماعات بشكلٍ أو بآخر..
يختم محمد فرح ابن الجولان حديثه إشارة إلى شعور بالانتقاص، انتابه عندما قرأ لأول مرة عبارة “مخيم النازحين” إلى جانب اسم المنطقة التي انتقل إليها مؤخراً وهي “جديدة الفضل” بريف العاصمة، ليكتشف لأول مرة أنها تُعرف على أنها مخيم للنازحين. نازحون من قطعة جغرافية مسلوبة من ذات البلد الذي يُؤكّد دائماً تمسكّه بهذه القطعة.
تركت تلك اللصاقة الورقية في الميكرو باص والتي وصفها محمد ب “العنصرية”، أثراً عميقاً في نفسه وتساءل، هل لأنني أُجبرت على مغادرة أرضي في الـ 67 ستبقى كلمة “نازح” تلاحقني طيلة حياتي حتى وأنا في وطني!
تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع صوت وصورة وصدى الذي تنفذه مَوج 2021